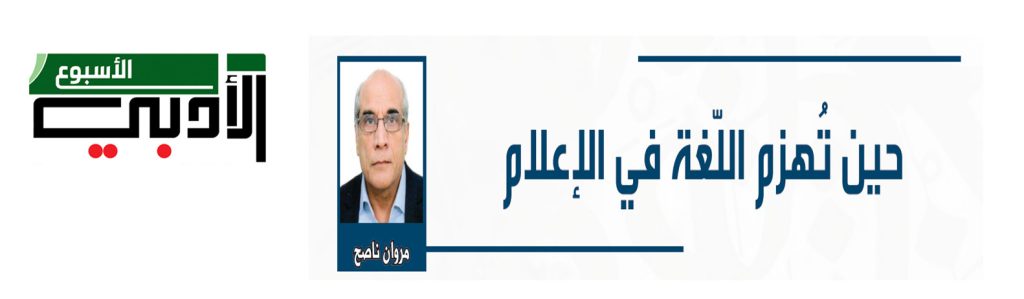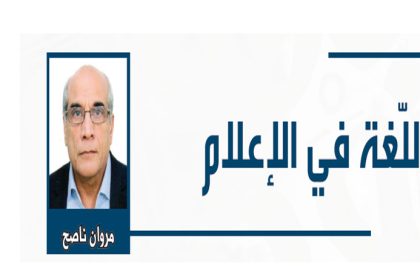مروان ناصح
في الماضي، حتّى القريب منه، لم يكن الإعلام مجرّد وسيلة لنقل الخبر والمعلومات، بل كان مؤسّسة لغويّة قائمة بذاتها، تنطق باسم الأمّة، وتحرس فصاحتها.
كان المذياع، في صباحات البيوت، يعلّم النّطق الصّحيح أكثر ممّا تفعل المدارس، وكانت نشرات الأخبار تُقدَّم على لسان مذيعين لا يقلّون انضباطًا عن الشّعراء، ولا يُخطئون كما يخطئ العابر في السّوق.
كانت اللّغة في الإعلام تؤخذ على محمل الجدّ، ليست مجرّد زينة، بل هُويّة.
الفصحى لم تكن ترفًا ولا عبئًا، بل معيار للجودة، وجواز عبور نحو المصداقيّة.
في تلك الأيّام، كان الإعلام يُدرّب كوادره كما يُدرَّب الممثّل المسرحيّ على مخارج الحروف، تُراجع النّصوص كما تُراجع الخطب الكبرى، وكانت الأخطاء اللّغويّة نادرة حتّى أنّها إذا وقعت، عُدّت حدثًا يستحقّ التّنويه، بل ربّما الاعتذار، كانت الفصحى أشبه بميثاق غير مكتوب بين المذيع والمشاهد: أنَّ ما يُقال على الشّاشة لا يكتفي بصدق المعلومة، بل يلتزم بصدق اللّسان أيضًا.
غير أنّ الصّورة تغيّرت تدريجيًّا، وفي كثير من الأحيان، دون مقاومة.
مع صعود الفضائيّات في التّسعينيّات، ثمّ اجتياح الشّاشات الرّقميّة ومنصات التّواصل الاجتماعيّ في العقدين الأخيرين، بدأت اللّغة تتراجع خطوة بخطوة، لم تعدِ الفصحى شرطًا، بل صارت عبئًا لدى بعض المؤسّسات الإعلاميّة، وبدلًا من أن تكون اللّغة الفصيحة مطلبًا للوضوح والرّصانة، أصبحت –في نظر بعضهم– «مشكلة في الإيقاع» أو «حاجزًا مع الجمهور».
تسلّلت العامّيّة إلى نشرات الأخبار، ودخلت الأخطاء إلى العناوين العريضة، وصارت اللقاءات تُبثّ بلا تحرير لغويّ، ولا مراجعة أسلوبيّة، المقدّم يسأل بلهجة دارجة، والضّيف يجيب بركاكة محشوّة بالتّكرار، ولا أحد يلتفت إلى أنّ الفاعل قد انقلب مفعولًا به على الهواء مباشرة، وحتّى المراسلون الّذين كانوا يومًا فرسان اللّغة في الشّوارع، لم يعودوا يُلامون إن أضافوا «السّين» إلى فعل ماضٍ، أو خلطوا بين المثنى والجمع، أو أغفلوا تمييزًا، فما عاد الجمهور يتوقّع منهم الفصاحة، بل أن «يُنجزوا» مهمّة التّغطية فحسب!
أسباب التّراجع
لم تُهزم اللّغة في معركة شرسة، بل تآكلت ببطء، هزمتها التّساهلات وتراجع المعايير وغياب الرّقابة اللّغويّة، والارتهان لسرعة البثّ، وتقديس الخفّة على حساب العمق، ومع دخول الإعلام التّجاريّ والسّباق على نسب المشاهدة، أصبح «الوصول السّريع» أهمّ من «الوصول السّليم»، صار التّركيز على اللّقطة المثيرة والصّوت العالي أكثر من التّركيز على وضوح الكلمة ودقّة التّعبير.
وتضافرت إلى ذلك عوامل خارجيّة: العولمة الّتي جعلت اللّغة الإنكليزيّة مرجعًا في كثير من المصطلحات، ضعف المناهج المدرسيّة في تعليم الفصحى، إغراءات اللّهجات المحلّيّة في استقطاب المشاهدين، بل حتّى ضغط المعلنين الّذين يرون أنّ العامّيّة أقرب إلى لغة السّوق.
آثار لغويّة وحضاريّة
اللّغة ليست أداة محايدة، بل هي وعاء للفكر، حين يتعوّد جيل كامل على إعلام ركيك، فإنّه لا يخسر مفردات فصيحة فحسب، بل يخسر معها معيارًا للجودة في التّفكير ذاته، الفصاحة الّتي كانت مرآة لما يليق صارت تُعامل كترف زائد، والجيل الجديد لم يعد يرى في اللّحن عيبًا، وحين تضعف اللّغة في الإعلام، فإنّ التّعليم نفسه يتأثّر، إذ يفقد المعلّم مرجعًا كان يستند إليه: كيف يقنع الطّالب بأهمّيّة الإعراب إذا كان المذيع نفسه لا يميّز بين المبتدأ والخبر؟
إن سقوط اللّغة في الإعلام لا يعني خسارة شكل فحسب، بل خسارة مضمون أيضًا، فالكلمة الرّكيكة لا تنقل الخبر بوضوح، ولا تُعين على التّحليل، بل تفتح الباب أمام الغموض وسوء الفهم، ومع الوقت، يصبح الخلل اللّغويّ جزءًا من الخلل المعرفيّ، ويُصاب الوعي العامّ بالتّشويش.
مقارنة مع لغات أخرى
من المفيد أن نلتفت إلى تجارب لغات أخرى، فالفرنسيّون، على سبيل المثال، يفرضون حماية صارمة للغتهم في الإعلام الرّسميّ، ويرون أيّ انتهاك للفصحى الفرنسيّة إساءة ثقافيّة، حتّى في الإنكليزيّة، برغم مرونتها، نجد مؤسّسات إعلاميّة كبرى مثل الـ”BBC” لا تتهاون مع الأخطاء النّحويّة أو اللّفظيّة، بينما يغيب في الإعلام العربيّ هذا الحسّ الحارس، وكأنّ اللّغة لم تعد جزءًا بالغ الأهمّيّة من الهُويّة.
بارقة الأمل
ومع ذلك، لم يُغلق الباب تمامًا، ما تزال هناك قنوات تقاوم السّقوط، ومذيعون يُصرّون على الإتقان، ومشاهدون يشتاقون إلى النّطق السّليم، بل إنّ بعض المنصّات الرّقميّة الشّابّة بدأت تكتشف أنّ الفصحى يمكن أن تكون جاذبة إذا قُدّمت بروح جديدة، في «فيديو» قصير أو «بودكاست» حيّ، يجمع بين الرّشاقة والوضوح.
ليس المطلوب أن نستعيد الماضي بحذافيره، بل أن نبتكر شكلًا إعلاميًّا جديدًا يُزاوج بين الحداثة والفصاحة، بين الإيجاز والبلاغة، وبين الشّاشة والبيان.
إنّ الإعلام الّذي نحتاجه هو ذلك الّذي يدرك أنّ اللّغة ليست محضَ «ديكور» وشكليّات، بل شريك في صناعة المعنى.
خاتمة
حين يُهزم الإعلام لغويًّا، فإنّه لا يُهزم في صياغة الخبر فحسب، بل في صياغة الوعي، اللّغة ليست وسيلة نقل وكفى، بل وسيلة تشكيل وبناء، ولها من التّأثير ما يجعلها شريكة في كتابة التّاريخ، أو في تزويره، ولهذا فإنّ سقوط اللّغة في الإعلام ليس خطًأ مطبعيًّا… بل انزلاق حضاريّ يهدّد وعينا الأصيل في الحاضر والمستقبل.
(نشرت في العدد 1925 من الأسبوع الأدبي)