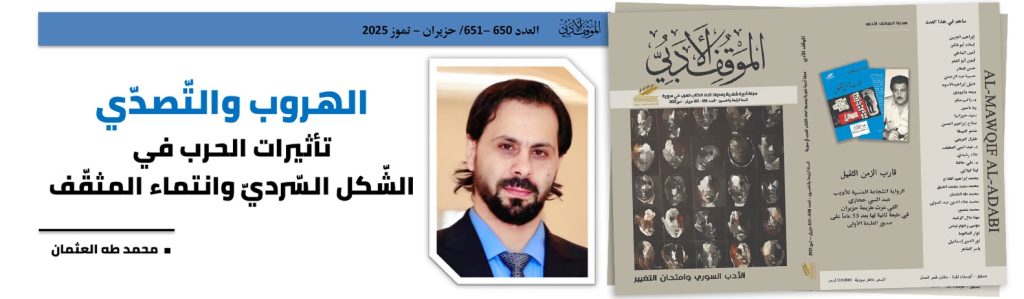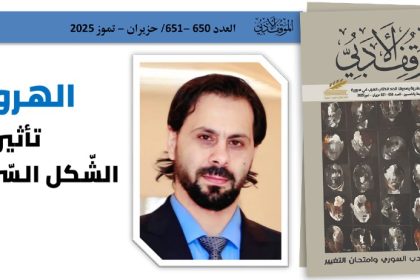د. محمد طه العثمان
غلبت سمة ما بعد الحداثة على كثير من الروايات السورية التي نُشِرت في السنوات الأخيرة، وكُتبت عن الواقع السوري المتشظي، من خلال نقل اشتراطات الواقع الجديد، إزاء تفتّت الهويّة الاجتماعيّة.
حين أعادت النظر في التقنيات السردية النمطية كـ(الشخصية، والحبكة، وصورة الراوي) محاولة خلق عفوية مُؤّثرة تكتسي أبرز هذه التقنيات، واستنباط تشكيلات أخرى مرتبطة باللعب والعبث، مما يعكس صورة المجتمع غير المكترث أيضًا؛ وهذا يساعد بالضرورة على تخطيّ للزمان والحدث معًا في داخل بنيّة السرد، وجعل الزمن بالفعل زمنًا مفتوحًا، والقفز على مبدأ التجانس والغائية، من حيث كونها تنشد مكونات بنائية غير نمطية، تساعد على التجريب وفتح مسارات جديدة في الخطاب السردي الروائي، الذي يسعى إلى هدم القناعات السائدة، والبحث عن فعاليات سردية وجمالية بديلة؛ لتأسيس خطاب روائي متميز لا يقع بمطبات الحداثة ورؤيا السارد صاحب المقولات المكتملة والمكتنزة على الحقيقة.
هنالك أسباب كثيرة دعت إلى هذا الانفتاح، عندما واكبتْ هذه الأعمال ضمير الشعوب وآمالها، واقترب الكاتب من ذات المتلقي وتحدث عنه وعن أحواله بطرق مختلفة، أضف إلى الاهتمام العالي بالبناء الفني والتقني للرواية الجديدة من حيث الشكل والمضمون.
فحتى نتمكن من توصيف هذا التطور ونراعي تقنيات السردية الجديدة للرواية، فلا بدَّ من التعامل معها على أنها جنس مستقلٌ بذاته وكائن حي مستمر النمو دائماً، وواجب علينا البحث عن المفاتيح الأساسية لمواكبة هذا التقدم، بما ينطوي عليه من آليّات جعلت /الرواية/ ديوان العرب في القرن العشرين، في خصوصية التقنيات وهندسة الفضاء والشكل المعماري، والتعرف على مؤثرات الروائيّ في اختيار المعمار المناسب لروايته من دون التفكير بقوالب مسبقة لتشريحها.
بمعنى أدق هل يجب علينا الانطلاق من أكثر من مبدأ في التعامل مع النصوص. والاعتماد على المبدأ التفاعلي بين النص والقارئ، وألا نفرض على الكاتب نظرية أو قراءة مسبقة، لتحقيق هذه التقنيات.
وحين نخصص ونحدد الدائرة فلم تكن تأثيرات ما بعد الحداثة على حياة السوريين مُرتبطة فعليًا بالحرب، ذلك أن ما بعد الحداثة هي حقبة تاريخيّة عالمية، وانعكاساتها طالت السوريين بوجهٍ خاص، والعرب بوجهٍ عام، لكنَّ الحرب السورية كشفت القناع سافرا عن تأثيرات ما بعد الحداثة، وأنماط تعينها في المجتمع السوري الذي تعرَّض لاختبار أقل ما يقال عنه إنَّهُ اختبار قاسٍ وفادح.
وكان من الواضح جلياً أنَّ الحرب في سورية قد عمَّقت الشُّروخ النَّفسيّة والاجتماعية في الوطن السوري، وهذا ما وأد إمكانية حضور الأنماط المعيشية ما بعد الحداثية في الفضاء الاجتماعي السوري، فاللاجدوى والتصارع الحربي الذي مزق المجتمع، انتقل إلى جميع طبقات هذا المجتمع ليقذف بها في حركات عشوائيّة غير متماسكة، أقرب ما تكون إلى حالة التفتيت التي تمزق عبرَها المجتمع، وأعاد توضّعَه في أنماط معيشية لا منطقية وغير مفهومة.
إن غياب المركزية الهرمية المعروفة في الثورات أو الحروب التَّقليديّة، وثم فقدان الحدود الواضحة بين المراكِز والهوامش، أدى إلى ضياع الحدود الفاصلة بين ثقافة النخبة وثقافة العوام الشعبية. وهذا أمر جيد إنْ كان هناك مشروع أصيل لتقديم الثقافة الجادة وجذب العوام إليها، لا لتمييعها، وحجب دور المُثقف والثقافة عن العوام، بغض النظر عن تحليلنا لمُصطلح النخبة ودلالاته الذي ليسَ مكانه في هذا السياق.
هذه بعض من الأسباب جعلت المجتمع السوري يفتقد رويداً رويداً للنسق المُتماسك، وبدأ يدخل نفقًا لا نهائيًا من الانقسامات البنيوية والقيمية، فقد ساعدت ردّة الفعل المفرطة في العنف من نظام الأسد على الحراك السلمي ليتحول بعدها إلى حرب ومحرقة طالت كل المستويات وأخص بها هنا الثقافية والاجتماعية على الالتحاق الثقافي والاجتماعي تلقائياً بثيمات ما بعد الحداثة، وهو الأمر الذي تجسَّد في حالة الاصطفاف والتَّخندق الشعوري والسياسي الذي غلَّف الحالة الاجتماعية التي بدت أشبه بشذرات ما بعد الحداثة، حيث بات من شبه المُستحيل إيجاد قواسم مشتركة بين الناس على الأقل واقعياً لا تنظيريا.
لذلك فإنّ الصراع الشديد الذي حصل ولّد تهميش لصوت النخب ووأد أي محاولة للتقارب من عقلاء الطرفين، فلم يظهر التفتت المشار إليه على مستوى الفعل الحربي الذي قسّم المجتمع إلى متواليات من الشظايا المتسارعة، لكنه ظهر أيضًا في الموقف النّفسي والفكري اجتماعيًا، حيث بات سؤال الانتماء، أو بالأحرى سؤال اللا انتماء سؤال الراهن الواقعي الاجتماعي سوريًّا، وبات البحث عن جواب يحدد دلالة مفردة (الوطن) جوابًا مشوبًا بالضبابية وعدم اليقين.
وفي الرجوع إلى الماهية التي جعل فيها النظام هذه الكينونة غير منتظمة نلاحظ، أن حالة من عدم التماثل والتوازن شابت هذه الكينونة، فاختلط الأمر أكثر عند بدء الحراك السلمي، مما جعل عددًا من الأطراف تعيش في ضبابية وعدم رؤيا واضحة للأمور، بسبب هذا التداخل الممنهج والمكرس منذ خمسين عامًا، إن هذه الضبابية زادت من صعوبات فهم ما يحدث، ولماذا يحدث كل هذا، بخاصة إذا حاول أن يلجأ الفرد إلى القياس الذي لا ينجو في الأغلب من سجن الأيديولوجيات المُسبّقة بعكس هذه الثورة المباغتة وغير المركزية، فعندما يعجز الفرد عن تفسير الأحداث الجديدة والشاذة والغريبة أو حتى الغرائبية يلجأ تلقائيًا إلى محمية (نظرية المؤامرة) المريحة للأعصاب والضمير.
وهكذا، تُغيَّب الذاتُ ويَتم ُّسحقها لصالح بشاعة الواقع من جهة، ومسلمات باتت أكبر من المجتمع نفسه في محرقة بشعة من جهة أخرى. من هذا الباب جسَّدت منظومة ثيمات ما بعد الحداثة مدخلاً عريضًا تأسَّس عليه امّحاء الذات الفردية في ظل فقدان توازن العلاقة الاجتماعية/ السياسية بين الفرد ومحيطه، فظهرت حالتان متناقضتان شديدتا التطرف لهذه الذات الفردية والجمعية المُتفتّة، هما:
1_ تضخم الذّات، وتعمّق البعد النرجسي المتضخم أفرادًا وبيئات محلية.
2_ تهميش الذات، وانسحاق الكيان الفردي والجمعي.
وعبر هذين القطبين، اتسع بروز ظاهرتين اجتماعيتين أيضًا، هما:
1_ الإيمان التعويضي الأعمى ببعض الأفكار أو الانتماءات التي تؤكد التشظي والصراع الاجتماعي، ولا تنفيه.
2_ وفي الوقت نفسه انتشرت ظاهرة عدم الركون إلى أي معتقد أو انتماء أو انتساب سياسي أو اجتماعي.
ولأنَّ المثقف ابن بيئته، وابن مجتمعه، انعكست تأثيرات الحرب بما هي تجسيد لثيمات ما بعد الحداثة على المثقفين السوريين، الذين عاشوا بدورهِم حالة من الشروخ النفسية والثقافية والفكرية، حيث تشظَّى المشهد الثَّقافي على نحْوٍ عام، وبدا كأنَّهُ لوحة غير مُتماسكة فسيفسائياً في ضوء التمترس غير المسبوق، والتخندق الذي هشمّ الفضاء الثقافي، وأظهر تشظيه إلى أقصى الحدود بين جملة تصنيفات أو صفات أو سمات تؤكِّدُ تحلّل النسق الثقافي إلى شظايا أو شذرات على مُستوى البنية المشهدية.
وبطبيعة الحال، انتقل هذا التّحلُّل إلى أسئلة الثّقافة نفسها عند المثقف، الذي بدا كأنه قد استسلم إلى حد بعيد إلى آليات التهشيم العشوائية، والتي كشفت عن حجم الهوة الثقافية في الآراء والمواقف المُتّخذة داخل دوامة الحرب السورية، وكما كنا نكاد لا نجد قواسم مشتركة تجمع الناس على المستوى الاجتماعي، افتقدنا للخطاب الثقافي الجامع، في ظل التخندق والانقسام والتشظي الذي حلّ بالمثقفين السوريين.
لقد بدا جليًا سقوط نسبة لا يستهان منها من المثقفين السوريين في عدمية فقدان الانتماء، وصعوبة إيجاد أجوبة مقنعة حول أسئلة معقدة، كسؤال الانتماء، أو سؤال الوطن والوطنية، لذلك تجلت تأثيرات ما بعد الحداثة على الحامل الحربي في أنماط متسارعة من الشعور بعدم اليقين والالتباس والغموض والارتياب والاستلاب.
وهكذا، عانى المثقف السوري، مثله مثل المواطن العادي من صراع عنيف وعميق بين تضخم الذات وامحائها من جانب أول، وبين الانتماء الأعمى لتيار أو فكرة تُعمّق التشظي لا ترتقه، ورفض الانتماء إلى أي فكرة أو بنية أو بيئة، وهو الذي ترك أثرًا واضحًا على المُنجز الثقافي الذي بدا مفككًا، وخارج السياق العام في كثير من الأحيان، ومنفصلاً عن الواقع في تجارب كثيرة أخفقت في إيجاد التوازن أمام تيار التشظي الجارف.
إنَّ كلا المشهدين الاجتماعي والثقافي السوري عانيا، وما زالا يعانيان من أزمة هوية وانتماء حادة، تطفو بقوة في أفعال الاغتراب على المستوى الواقعي، وتنعكس على نحو حاد في المُنجز الثقافي الذي يبدو أنه ينوس بين الهروب من الواقع والتّصدي لأسئلة الانتماء والوطن والوطنية المُلحة، من دون أن ينجو النمطان (الهروب والتصدي) من عمق تأثيرات الامحاء، والتشظي الذي تلتبس عبره الأعمال الثقافية المتنوعة شكلاً ومضموناً، وتكشف حالة جامحة من الالتباس وعدم اليقين المغرقان في معظم الحالات في أنماط من الكآبة واليأس والتّشاؤم والسوداوية التي ولّدتها الحرب في مجتمع افتقد البنية المتماسكة، وهو الأمر الذي ما يزال يترك بصمته الموجعة بعمق على المُثقفين ومنجزهم الثَّقافي في الوقت نفسه.
_________
نشرت في مجلة (الموقف الأدبي) العدد المزدوج (650- 651) الخاص بـ”الأدب السوري وامتحان التغيير”