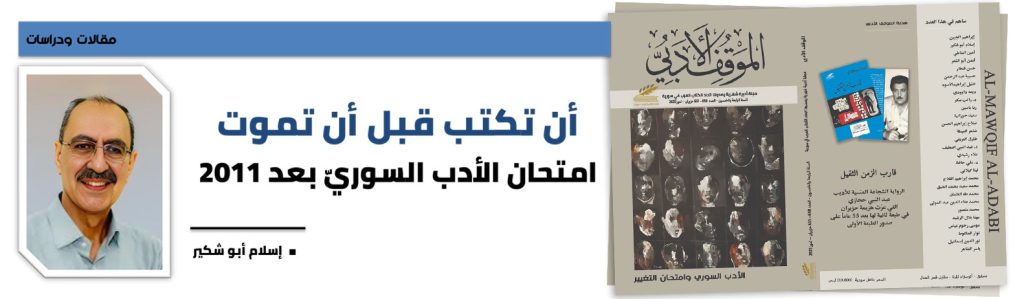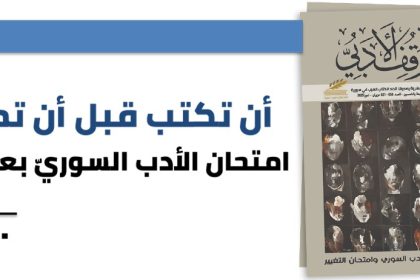امتحان الأدب السوري بعد 2011
– إسلام أبو شكير
لم تكن التجربةُ الأدبيّةُ السوريّةُ، منذ تشكّلها الحديث، بمنأى عن الهمّ العام، لا سيّما السياسيّ. فمنذ بدايات النهضة، مروراً بمرحلة الاستعمار الأوروبيّ، ثمّ الاستقلال، وصولاً إلى عقود الحكم الشموليّ في عهدي الأسدين، انشغل الأدب السوريّ بقضايا الاستبداد، والاستقلال، والتحرّر الوطنيّ، والحرّيّات العامّة، والصراعات الحزبيّة، والقضايا القوميّة، متناولاً هذه الإشكالات من زوايا نظرٍ متعدّدة، وبرؤى متباينة، وضمن أشكال فنّيّةٍ متنوّعة.
وعلى امتداد هذه المسيرة، برزت أسماءٌ أدبيّةٌ أسهمت في تشكيل النسيج الحيّ للتجربة السوريّة الحديثة. ورغم تنوّع الأساليب والرؤى والمواقف، وتفرّدها أحياناً، فإنّ التراكم الذي أنجزه هؤلاء منح التجربة هويّتها وملامحها الخاصّة، بوصفها حقلاً تتقاطع فيه الوظيفة الجماليّة مع الوظيفة الفكريّة، ويتداخل فيه التعبير الفرديّ بالشأن العامّ.
وللتمثيل لا الحصر، يمكن الإشارة إلى شعراء مثل شفيق جبري، خليل مردم بك، خير الدين الزركلي، بدوي الجبل، عمر أبو ريشة، نزار قباني، رياض الصالح الحسين، محمد الماغوط، سنيّة صالح، شوقي بغدادي، وممدوح عدوان؛ وإلى روائيّين وقصّاصين ومسرحيّين من أمثال عبد السلام العجيلي، حنّا مينة، هاني الراهب، غادة السمّان، إلفت الإدلبي، فاضل السباعي، عبد النبي حجازي، نبيل سليمان، خيري الذهبي، فوّاز حداد، ممدوح عزّام، سمر يزبك، فؤاد الشايب، زكريّا تامر، سعيد حورانية، جورج سالم، غالية قبّاني، سعد الله ونّوس، وفرحان بلبل.. وآخرين..
هذه التجربةُ التي راكمها هؤلاء، ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بسياقاتها السياسيّة والاجتماعيّة، وأفرزت أنماطاً واضحة المعالم، مثل: أدب المقاومة، وأدب السجون، وأدب الحرب، والأدب المتحزّب، والأدب الملتزم…
وقد تفاوتت هذه الخطوط أو التيّارات العامّة في مرجعيّاتها الفكريّة، وفي توجّهاتها الفنّيّة بطبيعة الحال. كما تراوحت بين ما هو تحريضيٌّ مباشر، يسعى إلى التأثير والتعبئة، وبين ما هو رمزيٌّ مراوغٌ يعمل على الحقول الدلاليّة من أطرافها، ملتزماً بلعبة التشفير والتحايل على الرقابة بشقّيها: الحكوميّ الرسميّ، والعامّ الذي تفرضه الثقافةُ السائدة. كما اختلفت الأرضيّات الفكريّة للنصوص المنجَزة، فبعضها استند إلى إيديولوجيا واضحة: قوميّة، ماركسيّة، إسلاميّة..، وبعضها الآخر عبّر عن وعيٍ نقديّ فرديّ مستقلّ بعيدٍ عن أيّ انتماءٍ حزبيّ أو عقائديّ محدّد.
أدب السجون، على سبيل المثال، أدّى دوراً محوريّاً في فضح آليّات الاستبداد، وتوثيق تجربة القمع المنظّم؛ بينما شغل أدب المقاومة موقعاً مركزيّاً في الوجدان الوطنيّ، خصوصاً فيما يتّصل بالصراع مع الاحتلال الإسرائيليّ لكلٍّ من فلسطين والجولان أو حتّى لأجزاء من لبنان في بعض المراحل. أمّا ما اصطُلح على تسميته بـ (الأدب الملتزم)، بالمعنى الذي شاع في ستينيّات وسبعينيّات القرن الماضي، فقد سعى إلى تقديم الرسالة السياسيّة والأخلاقيّة على ما هو جماليّ، باعتبار أنّ الجماليّ سيكون حاصلاً طبيعيّاً وتلقائيّاً طالما حرص النصّ الأدبيّ على أن يكون “مرآةً” تعكس “قضايا الجماهير”، وأن يعبّر عن “صوت الطبقة المهمّشة أو المسحوقة” في المجتمع.
ورغم تفاوت القيمة الفنّيّة والفكريّة لما أنتجتْه هذه التيّارات، فقد أثّرتْ مجتمعةً في الوعي الأدبيّ السوريّ عقوداً طويلة، وأسهمتْ في بلورة تصوّراتٍ متنوّعةٍ حول “وظيفة الأدب” و”الموضوعات الجديرة بالمعالجة”.
هذه التصوّرات ستُعادُ مساءلتُها لاحقاً، بعد عام 2011، حيث بدأت كثيرٌ من النصوص تميل إلى النأي عن تلك الأدوار التقليديّة، وتتّجه نحو مساحاتٍ أكثر تعقيداً وتداخلاً، وذلك بتأثير الزلزال السياسيّ والمجتمعيّ الذي انطلق في ذلك العام، وما تلاه من تحوّلاتٍ جذريّةٍ في البنى الفرديّة والجماعيّة على السواء.
والواقع أنّ التحوّل الذي انطلقتْ شرارتُه عام 2011، بما حمله من عنفٍ غير مسبوق، وبما فتحه في الوقت نفسه من آفاقٍ لتوقّعاتٍ وآمالٍ بدت مستحيلةً على الدوام، قد وضع التجربة الأدبيّة السوريّة أمام امتحانٍ جديدٍ ومعقّد. فهي مطالبةٌ من جهةٍ بمواكبة الحدث الصاخب المتسارع وتوثيقه، كما يحدث في كلّ منعطفٍ كبيرٍ، ومطالبةٌ في الوقت نفسه بألّا تخسر توهّجها الإبداعيّ، أو تُسقِط البُعد الفنّيّ الذي راكمتْه عبر المراحل السابقة، وبات رصيداً يُحسَب لها؛ لصالح تعبيرٍ مرتجَلٍ تبدأ دورة حياته بانطلاق الحدث، وتنتهي بانتهائه.
لقد كان من الطبيعيّ (بل المتوقّع) أن يستجيب الكثير من الكتّاب، لاسيّما الشباب، لهذا الانفجار، بانخراطٍ مباشرٍ في توثيق الحدث، أو التعبير عنه بوسائط سرديّةٍ وشعريّةٍ وفنّيّةٍ تستمدّ مادّتها الأوّليّة من التجربة الشخصيّة، أو المعايشة المباشرة.
وصولُنا إلى هذه المرحلة يقتضي منّا الوقوف على نحوٍ أكثر تفصيلاً عند أبرز ملامح المنجز الأدبيّ فيها أو بعدها، وهو ما يمكن إجمالُه في أربع نقاطٍ رئيسيّة:
1- قبل القتل أو الضياع:
من الاعتقال السياسيّ، إلى الهروب والمطاردة، مروراً بالنزوح واللجوء، وصولاً إلى فقدان الأحبّة، ودمار البيوت والمدن، اتّجهت نسبةٌ كبيرةٌ من النصوص إلى تحويل هذه الوقائع إلى نواةٍ مركزيّةٍ للكتابة، أو إلى ما يشبه “الواجب الأخلاقيّ” لدى بعض الكتّاب الذين رأوا أنّ الصمت أو الإحجام عن التوثيق، نوعٌ من الخيانة أو التواطؤ.
لقد بدا الأدب السوريّ بعد 2011، في كثيرٍ من نماذجه، وكأنّه في سباقٍ مع اللحظة، أو كأنّ الكاتب يعيش إحساساً ضاغطاً بضرورة أن “يشهد” الآن، وأن يقول كلّ شيء قبل أن يتوقّف النزف، ويفقد الحدث حرارته، متحوّلاً إلى مجرّد ندبةٍ مؤلمةٍ في نقطةٍ قصيّةٍ من الذاكرة قد لا تثير انتباه أحد.
الأمر أشبه ما يكون بحالة “استنفار” سادت السنوات الأولى من الثورة خصوصاً، ثمّ استمرّت على نحوٍ أقلّ صخباً فيما بعد، حيث بدا أنّ الكاتب يريد أن يدوّن تجربته، أو شهادته في أسرع وقت، وذلك قبل أن يُقتَل، أو يُعتقَل، أو يضيع صوتُه في زحام الأحداث التي تعصف به وبمحيطه. وبدا كما لو أنّه يطالب القارئ بمواساته في محنته، قبل أن يجنح نحو “ترف” النقد أو التقييم أو الحكم.
وبالطبع فقد ترتّبتْ على ذلك كلّه نتائجُ وآثارٌ لا بدّ من رصدها، لتكتمل الصورة، وقد يكون من المناسب صياغة هذه الآثار على شكل أسئلةٍ تُترَك الإجابة عليها لدراساتٍ لاحقةٍ تحرص على تقصّي المنجَز من حيث الكمّ أوّلاً، ثمّ بقيّة الجوانب تالياً. وقد يكون أبرز هذه الأسئلة ما يمكن طرحُه حول ما حقّقه المنجَزُ على المستوى الجماليّ والفنّيّ، وعمّا إذا تمكّن من الارتقاء من هذا الجانب إلى مستوى ضخامة التحوّل التاريخيّ الذي عاشه البلد.
كما يمكن التساؤل عمّا إذا كان هذا النوع من الأدب -بحكم التصاقه اللحظيّ بالمأساة- قادراً على الصمود أمام الزمن، أو أنّ جزءاً منه -كبيراً أو صغيراً- سيبهت مع تراجع حرارة الحدث، ويبقى محصوراً في دائرة ما يمكن تسميته بـ “الأدب العابر أو الطارئ” الذي لا تتجاوز وظيفتُه اللحظةَ التي كُتِب فيها..
أسئلةٌ قد لا نقدّر أهمّيّتها الآن، لكنّها ستكون حاضرةً في مرحلةٍ لاحقةٍ ستأتي حكماً، وبالضرورة، عندما تتخطّى القراءةُ الناقدةُ المحلِّلةُ مهمّةَ البحثِ في القضايا والمضامين التي كتب السوريّون نصوصَهم عنها وفيها، إلى البحث في: كيف كتبوا؟ وبأيّ أدوات؟ وبأيّ حساسية؟ وبأيّ وعيٍ جماليٍّ أو فكريٍّ؟
2- الانفعالات تتدفّق:
من الملامح البارزة التي يمكن رصدُها في أدب ما بعد 2011 ظهورُ كتاباتٍ بدأت تتخفّف تدريجيّاً من عبء التقاليد الأجناسيّة الصارمة، وتتحرّر من الأطرِ الصلبةِ التي طالما ضبطت الممارسةَ الأدبيّةَ ضمن حدود ثنائيّاتٍ قاطعةٍ: شعر / نثر.. فنّ / توثيق.. قصّة / سيرة.. جماليّ / إيديولوجيّ.
في مكان هذه الثنائيّات أخذت تتبلور أنماطٌ جديدةٌ، هجينةٌ ومفتوحةٌ، تُزاوج بين: السرد، والتأمّل، والشعر، والنثر، واليوميّات، والشهادات، وأدب الرحلات؛ وأكثر من ذلك: بين الكتابة الأدبيّة والصحفيّة والرقميّة.
هي نصوصٌ يصعب تصنيفها تقليديّاً، لكنّها تعبّر بصدقٍ عن تحوّلٍ عميقٍ في علاقة الكاتب بالكتابة، وفي فهمه لوظيفة الأدب، ولطبيعته وحدوده أيضاً..
ولعلّ من أهمّ العوامل التي ساعدت في نشوء هذا التحوّل:
أ- صعود جيلٍ شابٍّ، يمتلك نزوعاً طبيعيّاً تلقائيّاً نحو المغايرة: فالشبابُ الذين وجدوا أنفسهم وسط واقعٍ تاريخيٍّ متفجّرٍ، لم يتمرّدوا على تركة القمع الثقيلة التي ضغطت عليهم وحسب، لكنهم امتلكوا أيضاً شجاعة كسر الأنماط القائمة، وتجاوز الحدود والمفاهيم المستقرّة الخاصّة بالإبداع وطرائق التعبير فيه، سواء أكان ذلك عن وعيٍ بحقيقة وطبيعة ما يقومون به، أو أنّه جاء على نحوٍ عفويّ فرضه الظرفُ المحيط بالكتابة.
لم يعد همّهم أن يكتبوا روايةً تنتمي إلى تقاليد الواقعيّة السحريّة مثلاً، أو قصيدةً عموديّةً متقنةً، بل أن يفصحوا عن هواجسهم، وأن يدوّنوا التجربة كما عاشوها، دون قلقٍ كبيرٍ تجاه المستوى، أو النوع، أو الشرط الفنّيّ.
ب- التعلّق بحرارة اللحظة، واعتبار الكتابة وسيلةً للنجاة: فكثيرٌ من هذه الكتابات انطلقت من شعورٍ داخليٍّ بأنّ التوثيق السريع هو فعلُ مقاوَمةٍ ضدّ النسيان، وضدّ القمع، وضدّ الموت. لقد كتب كثيرٌ من هؤلاء الشباب كما لو أنّهم يكتبون وصاياهم، أو كما لو أنّهم يطلقون صرخات استغاثة طلباً للمساعدة. وهذا ما يفسّر أحياناً طغيان الصوت الفرديّ، وتراخي البنية الفنّيّة، وتقدّم الوظيفة التعبيريّة أو الإبلاغيّة على الاعتبارات الفنّيّة أو الجماليّة.
ج- تنوّع وسائط النشر والتلقّي: إذ تزامنت الثورة السوريّة مع ثورةٍ رقميّةٍ فتحت فضاء جديداً وغير مسبوق أمام الكتابة، وكسرت احتكار السلطة لقنوات النشر والتعبير، من صحافةٍ، ودور نشر، وتلفزيون، وإذاعة، ومسارح، وصالات عرضٍ، سواء بامتلاكها مباشرةً، أو بإخضاعِها لرقابةٍ قاسيةٍ لا تسمح بأيّ استثناء.
مع الثورة الرقميّة أصبح بوسع الكاتب أن ينشر نصّه فوراً على الفيسبوك أو على أيّ منصّةٍ رقميّةٍ متاحة، وسيتلقّى خلال لحظات مئات التعليقات أو الردود. هذا الفضاء الجديد أعاد تشكيل مفهوم “الجمهور”، وغيّر طبيعة العلاقة بين الكاتب والمتلقّي، فلم يعد الكاتبُ يكتب لمتلقٍّ بعيد، بل لآخر يشاركه الجلسة حرفيّاً، ويعيش معه لحظة التوهّج الإبداعيّ كلّها تقريباً.
ورغم كلّ ما يقال عن تسرّب الفوضى والانفعال، أو التعجّل في بعض النصوص، فإنّ ذلك لا ينفي حقيقة أنّها تعبّر عن لحظةٍ إبداعيّةٍ مغايرةٍ، تتّسم بالتلقائيّة، وبالحسّ الشخصيّ العميق، وبالنزوع الداخليّ نحو التمرّد، واللامبالاة بالقيود المفروضة بشكلٍ مسبَق، والتي من شأنها أن تُوقِف تدفّق الأفكار والانفعالات، وتُفسِد حرارتها.
3- الأنا بلا قناع:
تبعاً لما أصاب الشكلَ من تغييراتٍ بنيويّةٍ، وتعميقاً لفكرة التعلّق بالتجربة الفرديّة، شهد أدب ما بعد 2011 بروز ما يمكن تسميته بـ “الأنا المركزيّة” في الخطاب الأدبيّ. فالكاتب خرج عن دور الوسيط الذي تقتصر مهمّته على نقل الحدث، ليصبح جزءاً من الحدث، ومشاركاً فاعلاً فيه، بل إنّ الحدث في حالات كثيرة باتت له أدوارٌ بالغة الخطورة والعمق في تقرير مصيره، وصياغة وعيه.
هكذا، خرجت الكتابة من نطاق (الشهادة) على الحدث والتي يقدّمها الكاتب من الخلف أو الأمام أو الأعلى أو الأسفل، لتصبح تصويراً من الداخل، أو من القلب.. وتقدّمت الذاتُ الكاتبة لتتصدّر واجهة النصّ، باعتبارها المعنيّةَ بما يقوله قبل أيّ طرفٍ آخر، فالكاتب إذ يتحدّث عن المنفى فلأنّه هو نفسه منفيّ، وعن الاعتقال فلأنّه هو نفسه معتقَل، وعن الخيمة فبوصفها الخيمة التي تؤويه، وكذلك عن الرعب الذي هو رعبُه، والجرح الذي هو جرحُه، والموت الذي موتُه..
وبفعل هذا الانخراط الكلّيّ في التجربة، كثيراً ما تماهى النصّ مع ما يشبه الاعتراف أو البوح، وأصبحت الحدود هشّةً بين التخييل والتصوير، بل إنّ المبدأ المتعارَف عليه حول ضرورة الفصل في الفنّ بين الشخصيّة وبين المبدع، أصبح في بعض الحالات يشكّل عبئاً على الكاتب، لأنّه يسلبه حقّه في التجربة، بأن ينسبها إلى آخرين افتراضيّين. وهذا ما حدا ببعض الكتاب إلى تصدير نصوصهم بملاحظات تنبّه إلى أنّ المضمونَ حقيقيّ، وأنّ الوقائعَ عاشها الكاتبُ نفسه، أو عايشها في الأقلّ، وأنّ الخيالَ في العمل يقتصر على تفصيلاتٍ لا قيمة لها.. وكأنّه يطالب مسبقاً بأن يصله حقّه في نصّه، وفي الموضوع الذي يعالجه..
وبالطبع فمن الظلم اتّهام هذه “الأنا المركزيّة” بالنرجسيّة، أو تلويثها بشبهة الاستعراض وحبّ الظهور والمغالاة في تقدير الدور، لأنّها جاءت ضرورةً حتميّةً، ونتيجةً منطقيّةً لما سبقها من مقدّمات، فهي المعنيّة المباشرة بالألم، وليست قناعاً لآخر تعاطفت معه أو تأثّرت بما كان يكابده.
ومن المهمّ الانتباه هنا إلى أنّ هذا البروز الطاغي للتجارب الذاتيّة، لم يكن يُقصَد به تغييبُ المأساة ببعدها الجماعيّ، بقدر ما كان تكثيفاً لها، وتجسيداً حسّيّاً عمليّاً لها، فالكاتب عندما يتحدّث عن مذبحةٍ شهد وقائعَها بنفسِه، فإنّه ينقل حكايته الشخصيّة حقّاً، لكنّه يستدعي معها وعبرها ظلال آلاف الحكايات الشبيهة، ممّن لم يُقيَّض لها صوتٌ يرويها، أو يفضحها.
4- من “هناك” إلى “هنا”:
إلى جانب الانزياحات الشكليّة التي ميّزت أدب ما بعد 2011، يمكن ملاحظة تحوّلٍ عميقٍ لا يقلّ أهمّيّةً على مستوى الموضوعات الأساسيّة التي شكّلت لسنواتٍ طويلةٍ عمادَ الخطاب الأدبيّ السوريّ.
فلعقودٍ كان الأدبُ في سوريا منشغِلاً -بصورةٍ مباشرةٍ أو غيرِ مباشرةٍ- بجملةٍ من القضايا الكبرى: القضيّة الفلسطينيّة، صراع الطبقات، صراع الشرق والغرب، المواجهة بين القوى الرجعيّة ونقيضتها التقدميّة، الاستعمار، شراهة الغرب وأطماعه في الثروة، الاشتراكيّة وحلم العدالة، الوحدة العربيّة..
غير أنّ الثورة التي انطلقت عام 2011 أحدثت انقلاباً في البوصلة، وبدا كما لو أنّ هذه الموضوعات فقدت وهجها، أو على الأقلّ لم تعد تحتلّ الصدارة في النصوص الجديدة، والسببُ ببساطة أنّ المأساة انتقلت من “هناك” إلى “هنا”، من المجرّد إلى المحسوس، من الخطاب العامّ إلى الحياة اليوميّة..
وبعد أن كانت الحرب ملحمةً تُخاض نظريّاً ضدّ “العدوّ الصهيونيّ”، أو “الإمبرياليّة الغربيّة”، أو “الرجعيّة”، أو “الإقطاع”؛ صارت اليوم مواجهةً فعليّةً ضدّ: السلطة، والأجهزة الأمنيّة، والميلشيات، أو حتّى ضدّ الجار المُخبِر، أو ابن الحيّ المتواطئ مع النظام..
والهدفُ لم يعد استقلالاً، أو سيادةً، أو رخاءً؛ بل نجاةً من رصاصةٍ عمياء، أو برميلٍ غبيّ، أو سوطِ جلّادٍ أصمّ.. أو ببساطة: الاستمرار في العيش كإنسان..
وكذلك صورةُ شجرة الزيتون المقتلَعةِ في فلسطين، فقد ظلّت جديرةً بالرثاء، لكنّها تراجعت لمصلحة بيت الكاتب نفسه الذي سُوّي بالأرض في مخيّم اليرموك، أو درعا، أو حمص، أو دير الزور، أو إدلب.
وحلم الوطن الكبير الواحد أصبح كابوساً يجثم على صدر النازح، والمعتقل، والأرملة، والطفل اليتيم..
وفكرةُ “تحرير العالم” احتلّت موقعَها فكرةُ تحرير الفرد من مسلخي صيدنايا وفرع فلسطين، فضلاً عن تحريره من رعبه، ومن خرسه، ومن ضياعه الطويل..
ليس ختاماً:
بعد ما يقرب من العقد ونصف العقد على انطلاقة الثورة في سوريا، يمكن القول إنّ الأدب لا يزال يعيش حالة مخاضٍ مفتوحٍ، يتلمّس طريقه بين ركام الذاكرة، وتقلّبات الواقع، والندوب العالقة في أعماق الذات.
لقد كسرت التجربةُ، بكلّ عنفِها وفرادتِها، كثيراً من الأطر السابقة، ودفعت بالأدب إلى مساحاتٍ لم يكن قد بلغها من قبل، سواءٌ من حيث الشكل أو الموضوع أو الموقع الذي يحتلّه الكاتب في خضمّ الحدث.
ومع ذلك، فإنّ ما نقرأه اليوم لا يمثّل خاتمة المرحلة. هو افتتاحيّةٌ لحساسيّةٍ جديدةٍ ستظلّ في طور التشكّل لسنواتٍ قادمةٍ، فأدب ما بعد 2011 ليس أدباً ناجزاً، بقدر ما هو مختبَرٌ مفتوحٌ للأسئلة عن:
– معنى الأدب بعد الفاجعة، والتحدّيات التي سيعيشها على مستوى القضايا، ثمّ على مستوى أدوات التعبير الجماليّ والفنّيّ..
– موقع الأدب بين حدّي: التوثيق للحدث، والتوثيق للإحساس..
– دور الذات وموقعها في النصّ..
– قدرة الكتابة على ترميم الإنسان وانتشاله من عذاباته، إضافةً إلى الأثر الذي ستتركه تجربة العقد ونصف العقد من الكتابة الطافحة بالألم في بناء جدار حمايةٍ للمجتمع يحول دون تكرار المأساة مستقبلاً..
– النقد وما يمكن أن ينتهي إليه بعد عمليّات التحليل الهادئ والمتأنّي لمجمل التجربة السابقة، ثمّ ما يمكن أن يفتحه من آفاقٍ مستقبليّة..
يضاف إلى ذلك كلّه السؤال الجوهريّ الذي لا بدّ من طرحه منذ الآن، والتفكير فيما ينفتح عليه من احتمالات:
– وماذا بعد؟
أسئلةٌ لا تنتهي، تماماً كما لا تنتهي جراحات وصرخات من وجد نفسه في قلب المحرقة.
_________
نشرت في مجلة (الموقف الأدبي) العدد المزدوج (650- 651) الخاص بـ”الأدب السوري وامتحان التغيير”