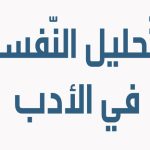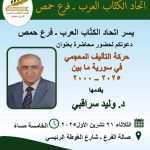رنيم مأمون الجنّـان
في أحد مواسم التاريخ التي تبدو فيها الكلمات أحجارًا بنّاءة قادرة على رفع أمة أو هدمها، جاء قرار الأكاديمية السويدية عام 1953م ليمنح سِير وينستون ليونارد سبنسر تشرشل جائزة نوبل في الأدب، معنونًا العبارة التي صارت مرجعًا لكل مَن يحاول أن يفهم سرّ هذا التكريم: «لإتقانه الوصف التاريخي والسيرة، ولبلاغته اللامعة في الدفاع عن القيم الإنسانية الرفيعة(1)».
في قراءة أولى يسهل ربط هذا القرار بكتابة ضخمة قامت على توثيق حدث كوني، وبخطابٍ استثنائي أنقذ نَفَس أمّة في زمنٍ قاتم، إن سلسلة «الحرب العالمية الثانية» وكتبًا أخرى مثل «تاريخ الشعوب الناطقة بالإنكليزية» ومذكرات متعددة؛ ليست مجرد مذكرات رجل دولة بل محاولة واعية لكتابة التاريخ من داخل غرفة القرار، بلغةٍ تتقاطع فيها الذاكرة مع التفسير والاستدعاء البلاغي، تلك المكتبة جعلت تشرشل كاتبًا له نصّه المؤثر في فهم القرن العشرين، ووفّرت مادة سمحت للأكاديمية بمنحه وسام الأدب على أساس «الإتقان التاريخي» لا على أساس الشعر أو الرواية المجرّدة.
لكن صورة التكريم لا تُفهم بالكامل إذا اقتصر النظر على كمّ الصفحات ونبرة السرد، ثمة بُعد آخر لا يقلّ أهمية، وهو بُعد الأداء الذي يجعل من الكلام نفسه فعلًا تاريخيًا وصنعًا إنسانيًا ذا نتائج ملموسة، في مخاطباته أمام مجلس العموم وفي خطبه التي جسدت لحظات المصير، لم يكتفِ تشرشل بسرد الوقائع بل صاغ بلاغةً عملية قادرة على إيقاظ الإرادة؛ في خطابه الأول كقائد للحكومة الحربية صرخ بما صار لاحقًا شعارًا للتصميم والعزيمة: «ليس لديّ ما أقدمه إلا الدم والكدّ والدموع والعرق(2)»؛ عبارة لا تُقاس فقط بجمالها اللفظي بل بثقلها التحريضي على الاستعداد للتضحية.
لم يكن الأداء وحده ما ألّب تقدير الأكاديمية له؛ فكتاباته التاريخية، وعلى رأسها مجلّداته عن الحرب العالمية الثانية، صنعت تأريخًا من داخل غرفة القرار، مراوحة بين السرد الروائي والتحليل السياسي، وبذلك قدّمت مادةً قادرة على تشكيل ذاكرةٍ جمعية بليغة؛ فهذا الجمع بين «إتقان الوصف التاريخي» و«البلاغة الدفاعية عن القيم الإنسانية» هو ما صنّفته لجنة نوبل كمسوّغ للتكريم.
بعبارة أخرى، الكلمات عند تشرشل لم تبقَ محض زخرفة؛ كانت أدواتٍ تحرّك المصائر، اقتباسًا من خطابٍ يوقظ المقاومة، سطرًا من مذكّرةٍ يؤسس لذاكرة بعيدة الأجل، وعبارة تُستعاد عند الحاجة لتعزيز معنى التضحية؛ وهذه البلاغة العملية، التي تُنتج فعلًا وتعيد تشكيل وعي أمّة بمعناه الأخلاقي والسياسي، كانت جزءًا لا يتجزأ من أسباب منح الجائزة، إذ كافأت الأكاديمية رمزًا كبيرًا يدافع بالكلمة عن قيم عُدَّت آنذاك «سامية» وذات أثرٍ عالمي.
إلا أن قراءة أخرى برزت خارج المرآة الرسمية التي لم تكن كلها تصفيقًا، فقد برزت اعتراضات أدبية وفكرية مباشرة بعد الإعلان ومن بُعد على السواء، وهي مقالة نقدية حادة عدَّتها نمطًا من الأساطير الذاتية التي ينسجها مؤلفو السِيَر؛ كمقال ريد ويتمور(3) في Yale View الذي رأى في سيرة تشرشل ميلًا إلى «صناعة الأسطورة» وتضخيمًا للدور الشخصي داخل سردية الحرب، إلى أعمدة رأي ورسائل عامة رأت أن الجائزة أشبه بمحاولة لتكريم رمز سياسي أكثر منها اعترافًا بإنجاز أدبي بحت.
على خطّ آخر، دافع نقّاد معاصرون بمرارة عن انتقادات أخلاقية ومنهجية؛ كتب ريتشارد لانجوورث على سبيل المثال مقالًا صريحًا بعنوان: «جائزة نوبل غير المستحقة لتشرشل» منتقدًا صيرورة التسويغ ومسقِطًا بعض الحجج الدفاعية حول أسباب المنح، على حين أعادت رسائل كُتّـاب مثل بروس روس- سميث إلى الواجهة استحضار أحداث مأساوية مثل مجاعة البنغال كدليل على أن تقييم ميراث الرجل لا يمكن فصله عن أبعاده السياسية والإنسانية(4).
ثمة مَن كتب أن أسماءً أدبية مثل فورستر أو غريفز أو أودن أو حتى بورخيس كانت تُذكر بين المرشحين المحتملين الذين «أُهملوا» لمصلحة رجل دولة مشهور، وهو ما غذّى شعورًا لدى البعض بأن الاختيار لم يكن محايدًا أدبيًا بقدر ما كان تعبيرًا عن اعتبارات زمانية وسياسية.
هذا الجدل يفتح بابًا لسؤال أوسع: ما حدود الأدب؟ إن فصل النص عن فعالية الكلام أو عن موقع مؤلفه السياسي يبدو من منظورٍ واحد ضربًا من النقاء النظري لا تعترف به ممارسات الحياة العامة، أليس الخطاب الذي يشحذ إرادة أمة في لحظة خطر أدبًا بذاته؟ أو نُعدِّه مجرد جمالٍ لفظي بحتٍ، مفصول عن تربة التاريخ؟ عندما نظن أن للأدب وظيفة واحدة تجريدية، قد نفقده كونه بعدًا أساسيًا؛ فهو قوة تنظيمية للذاكرة الجماعية، وهنا يتجلى سبب موقف الأكاديمية؛ التكريم لم يكن طفحًا جلديًا على ساحات السياسة فحسب، بل اعترا بأن السرد والتوثيق وخطاب الدفاع قد يشكّلون قيمًا أدبية إذا ما كان الهدف هو التأسيس لذاكرة الشعوب.
سردية أخرى أقل رومانسية تقول إن تشرشل نفسه لم يلقَ تكريمًا هادئًا؛ فقد تمنى، بحسب شهود مقربين، لو أنه نال جائزة السلام لأنه كان يود أن يُذكر كمُصلح ومُصالح قبل أن يُذكر ككاتب أو زعيم انتصاري، وفاتحة هذا التمني تلقي ظلالًا على علاقة الرجل بين رغبته الشخصية وصورة التكريم، كما أن انعكاسات القرارات الرسمية -مثل تغيب تشرشل عن مراسم الاستلام وإرسال زوجته لتسلّم الجائزة نيابةً عنه- أضافَ بُعدًا إنسانيًا مهمًا على سردية التكريم.
إلا أنّ قراءة قرار نوبل لا تنتهي عند وزن الصفحات ولا عند حسن السرد؛ ففي كثير من الأحيان تخلط الأكاديميات بين معيارَين: معيار أدبي جمالي محض، ومعيار واسع يختزل الأدب بوظيفة سياسية أو أخلاقية في زمن محدّد، هذه الازدواجية تظهر بوضوح حين نرى أسماء عربية تُردّدها الشفاه كمرشّحين طبيعيين للترشيح والجوائز الدولية منهم شعراء كمحمود درويش أو مثقفون عالميون كإدوارد سعيد، ثم تصل إلى نيل الجائزة، بينما تُكرَّم شخصيات أخرى لوزنها السياسي أو تصدّرها سردية تاريخية توافق لحظة التقدير، كثيرون رأوا في استبعاد درويش أو عدم منح سعيد الجائزة أمثلة على أن مواقف سياسية كدعم قضية فلسطين أو نقد الاستعمار أو الوقوف ضد الكيان الصهيوني يمكن أن يُضعف حظ المرشح في الساحة الدولية، حتى وإن كانت قيمة نتاجاته الأدبية لا جدال حول أهميّتها، وهذا نمط تفكير تكرّر في قراءة المراقبين والنقّاد الذين يتحدثون عن ميل المنح نحو مَن يخدم ذاكرة أوروبا أو الذين لا يخلخلون توازنًا سياسيًا معقدًا، ولا نستطيع الجزم بأن سبب الاستبعاد كان سياسيًا بحتًا، فوفق قواعد المؤسسة لا نستطيع الاطلاع على ملفات الترشيح والحجج الداخلية للجنة إلا بعد انقضاء خمسين سنة على كل سنة ترشيح.
وفي المقابل، ثمة أمثلة عربية نالت الجائزة فعلًا -كنجيب محفوظ لعام 1988- ويُستخدم وجوده كدليل على أن التتويج العربي ممكن، في المقابل، هذا لا يلغي أن عملية الاختيار بعيدة عن الحسابات الزمنية والثقافية والسياسية.
في ختام هذه القراءة، تظل جائزة نوبل كجهاز قياس معرّضةً للزمن والسياق، لا أنكر أن الأكاديمية تختار أحيانًا عن اقتناع فني، لكن علينا أن نعترف كذلك بأن آليات التقدير لا تكون نزيهة دومًا، وأن ذكرى الأسماء التي تُستثنى تفصح عن تحيّزات ثقافية وسياسية لا بدّ من مواجهتها، إذا كان الأدب يملك القدرة على تهديد موازين التاريخ، فلا بدّ أن نصرّ على أن يُقاس بمقاييس فنية إنسانية لا تُحتسب بمنفعة آنية أو فرضية سلطة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
Winston Churchill – Nobel Prize official citation (1953)
البيان الرسمي للجنة نوبل الذي يُذكر أن الجائزة مُنحت له (لإتقانه الوصف التاريخي ولخطاباته الدفاعية عن القيم الإنسانية السامية).
Churchill: A Life- Martin Gilbert
(السيرة المرجعية الأشهر لتشرشل على موقع Internet Archive)
https://archive.org/details/churchill00mart/mode/1up?utm_source=chatgpt.com.
Churchill and the Limitations of Myth- Reed Whittemore, Yale Review, vol: 44, no: 2, Winter 1954-1955, pp: 248-263.
Famine Inquiry Commission. (1945). Report on Bengal. Government of India. https://ia801500.us.archive.org/33/items/in.ernet.dli.2015.98599/2015.98599.Famine-Inquiry-Commission-Report-On-Bengal_text.pdf