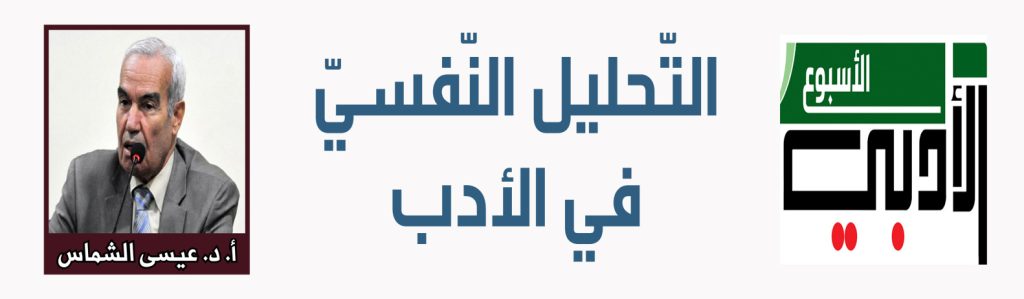أ.د. عيسى الشماس
(1)
يعرّف التّحليل النّفسيّ في الأدب: بأنّه أحد مناهج النّقد الأدبيّ الّتي تعتمد على علم النّفس لتحليل الأعمال الأدبيّة وتفسيرها، ويركّز هذا المنهج على دراسة العوامل النّفسيّة الّتي تؤثّر في إبداع الكاتب وإنتاجه الأدبيّ، وفي فهم الدّلالات النّفسيّة للنّصّ الأدبيّ، أيّ المعنى الّذي يعبّر عنه النّصّ من منظور نفسيّ.. فالتّحليل النّفسيّ في الأدب، طريقة علميّة لتحليل مضمونات النّصوص الأدبيّة الّتي تكشف عن خلفيّة الكاتب/ الأديب، الفكريّة والنّفسيّة، انطلاقًا من مبدأ: أنَّ كلَّ أديب أو كاتب، لا بدّ أن يترك بصماته الخاصّة على ما يكتب، سواءً كان شعرًا أم نثرًا، وقد بدأ النّقد النّفسيّ للأدب، بشكل علميّ منظّم، مع بداية علم النّفس ذاته، وعلى وجه التّحديد في نهاية القرن التّاسع عشر بصدور مؤلّفات «سيغموند فرويد» في التّحليل النّفسيّ، واستعان في هذا التّأسيس بدراسة ظواهر الإبداع في الأدب والفنّ كتجليات للظّواهر النّفسيّة عند الأدباء، وبذلك يكون التّحليل النّفسيّ في النّقد الأدبيّ، هو النّقد الأدبيّ أو النّظريّة الأدبيّة المتأثّرة بالتّحليل النّفسيّ الّذي أسّسه سيغموند فرويد، وقد يكون هذا التّأثير منهجيًّا أو مفاهيميًّا أو شكليًّا.
(2)
ثمّة باحثون ومختصّون في الدّراسات الأدبيّة، اعتمدوا في تحليل الأعمال الأدبيّة، أسلوب العامل النّفسيّ في تحليل النّصّ الأدبيّ، لمعرفة مدى ارتباطه بمشاعر الكاتب، ومدى مصداقيّة الكاتب ورغبته في التّعبير عن هذه المشاعر في نصّ شعريّ أم نثريّ، حيث يترجم أفكاره بلغة خاصّة وضمن مفاهيم معيّنة تتّفق مع رغبته في التّعبير عمّا في ذهنه من أفكار لها ارتباط قويّ بما يجول في نفسه، لذلك يتمثّل الهدف من النّقد الأدبيّ التّحليليّ النّفسيّ، في تطبيق التّحليل النّفسيّ على المؤلِّف أو على شخصيّة مميّزة في عمل ما.. إذ يطرح النّقد الأدبيّ التّحليليّ النّفسيّ أدلّةً مفيدةً في تحليل بعض الرّموز والأحداث والسّياقات المحيّرة ضمن عمل أدبيّ ما، كما هو الحال مع جميع أشكال النّقد الأدبيّ الأخرى، وفي المقابل، يتّسم النّقد الأدبيّ التّحليليّ النّفسيّ بكونه محدودًا، مثله مثل أشكال النّقد الأدبيّ الأخرى،
إنَّ تحليل الأدب من المنظور النّفسيّ، يركّز على رغبة الكاتب في التّعبير، الرّغبة الّتي تختلف عن الحاجة من الوجهة النّفسيّة والبيولوجيّة؛ فالرّغبة أقوى من الحاجة، فقد يشعر الإنسان بأنَّ لديه حاجة معيّنة لقضاء أمر ما، ولكنّه لا يشعر بالرّغبة في تلبيتها أو إشباعها، وقد يؤجّل قضاء هذه الحاجة أو يلغيها، ومن جهة أخرى، تختلف الرّغبة عن اللذّة الّتي تتضمّن إشباعًا مؤقّتًا يرضي حاجة بيولوجيّة، ترتبط بحالة التّوازن عند الكائن الحيّ، بينما تتجاوز الرّغبة الحدود الّتي يفرضها مبدأ اللّذّة، وبذلك تكون الرّغبة من الوجهة الأدبيّة هي ترجمةً فعليّةً لقضاء الحاجة إلى الكتابة التّعبيريّة وإشباعها، من خلال اللّغة المناسبة الّتي تحيط بالجوانب الّتي تتضمّنها الحاجة.
وعلى هذا الأساس نجدُ أنَّ التّحليلَ النّفسيَّ للأدب، لا يُعنى بحقيقة الكاتب البيولوجيّة فحسب، بل يأخذ بالدّور الّذي يضطّلع به ضمن وظيفته التخييلية أو الرّمزيّة، وهذا يرتبط برغبة الأنا، الّتي ترتبط بدورها في النّظام الرّمزيّ، أيّ اللّغة المستخدمة في التّعبير، والّتي ترتبط بالنّظام الرّمزيّ في الثّقافة الاجتماعيّة، وهنا تظهر الرّغبة الّتي تتّسم بالتّغيير والتّحوّل، وفق معطيات الواقع النّفسيّ للأديب.
(3)
يلاحظ ممّا سبق، أنَّ أصحابَ التّحليل النّفسيّ في الأدب يركّزون على الرّغبة الّتي تدفع الأديب إلى الكتابة؛ إذ إنَّ الرّغبة تساعد الإنسان في أن يعترفَ بنفسه تمامًا، مقابل أن يعترفَ به الآخرون، وهذا مرتبطٌ بمفهوم الأنا أو الذّات الشّخصيّة، فيتداخل ما هو ذاتيّ خاصّ بالمبدع مع ما هو موضوعيّ مستقلّ عنه، حيث يهتمّ المبدعُ بما يشغله هو شخصيًّا وذاتيًّا ولاشعوريًّا، وهذا ما دفع فرويد إلى القول: إنَّ اللّاشعور هو مصدر العمليّة الإبداعيّة، والأعمال الإبداعيّة هي ترجمة لمحتوى مستودع اللّاشعور من الرّغبات غير المشبعة، فيعبّر عنها بطريقةٍ تتواءم مع أعراف المجتمع وقوانينه؛ عن طريق آليات الدّفاع من تكثيف ورموز، ورأى فرويد أنَّ تاريخ الأدب يستمدّ كثيرًا من مقولاته ومصطلحاته في التّحليل النّفسيّ، حيث يقوم بإسقاط الانشغال الذّاتيّ على اختياره لبعض القضايا المجتمعيّة من دون غيرها، وهذا ما يظهر جليًّا وبوضوح في النّصّ الأدبيّ، سواءً كان نثرًا أم شعرًا، وعندها يكونُ هدف الرّغبة هو ما تكشف عنه المعرفة على نحو معيّن، وفي زمن معيّن.. وهنا نجد أنَّ الرّغبة واللّغة صنوان، وهما محور مضمونات الكثير من النّصوص الأدبيّة، فمن دون اللّغة المعبّرة، لا يمكن للرّغبة أن تتحقّق أبدًا في أيّ نصّ له صفة أدبيّة.
الخلاصة: لقد حقّقَ التّحليلُ النّفسيُّ نتائجَ مبهرةً في تعاطيه مع الأعمال الفنّيّة، بما فيها الأدب، وقد شجّع ذلك كثيرًا من النّقّاد على اعتماده منهجًا من مناهج النّقد الأدبيّ، فطبّقوا كثيرًا من نظريّاته، من أجل مقاربة النّصوص الأدبيّة: كنظريّة اللّاشعور، وعقدة أوديب وعقدة إلكترا، فالمنهج النّفسيّ يستمدّ آلياته النّقديّة من نظريّة التّحليل النّفسيّ، من خلال إخضاع النّصّ الأدبيّ للبحوث النّفسيّة، حيث يتمّ تحليل نفسيّة الكاتب وخصائص شخصيّته بالاعتماد على طبيعة حياته ومضمون كتاباته، وذلك بالاعتماد على فحص النّصوص الأدبيّة وربطها ربطًا وثيقًا بنفسيّة من أنتجها، مع الأخذ في الحسبان تأثيرات ما في داخل الشّخصيّة، من مكنونات وعُقَدٍ نفسيّة قد تؤثّر في طبيعة النّصوص الأدبيّة المـُنتجة.