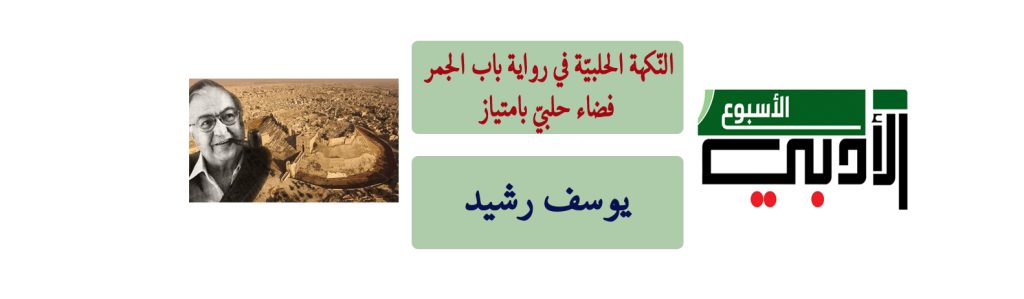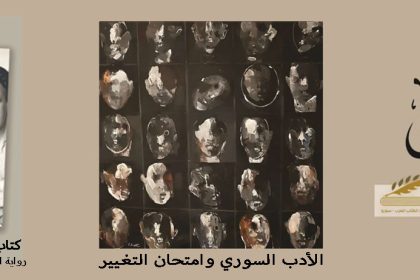يوسف رشيد
يقول عنها كاتبها الروائي وليد إخلاصي:
(بدت روايتي باب الجمر للوهلة الأولى وكأنّها بحث عن بابٍ غائبٍ أضيفه إلى أبواب حلب التّاريخيّة المعروفة، أو أنّه بابٌ متخيَّلٌ أدخل منه إلى حقيقة التّاريخ الاجتماعيّ للمدينة، لكن الأمر على ما يبدو أبعد من هذا بكثير).
“الرواية قبل الأخيرة: أحاديث للكاتب 1987”
ويقول: (أنا برأيي: ليس هناك من قانون للرّواية: لأن كل رواية تخلق قانونها).
“من حديثه في مقابلة خاصّة معي”.
هذه الرواية: هي واحدة من محاولاتٍ روائيّة كثيرة تسعى إلى تأصيل الرّواية العربيّة والابتعاد من النّمط الأوروبيّ الكلاسيكيّ وإيجاد نوع من الرّابط الحيّ بين نمط التّفكير الشعبيّ وعمليّة القصّ أو السّرد أو البناء الرّوائي عند الكاتب.
وليست هذه أول المحاولات، بل سبقتها رواية زهرة الصّندل، وبشيء أكثر هندسة في رواية الحنظل الأليف ذات الطابع التجريدي.
وتقوم رواية باب الجمر على عالم من الطّقوس والحكايات والاحتفالات والأحلام والرّجاءات والمخاوف الوثيقة الصّلة بالرّوح الجماعيّة الشعبية التي تعيد اكتشاف الحكاية الشعبية السورية.
وما يميّز هذا العمل هو حضور روح المكان، بخصائصه الاجتماعية وروحه الشّعبية.
وليست أسطورة حديثة أن نبتكر حارة على غرار حارات حلب القديمة، ونسميها باب الجمر، لأنّ ذلك مألوف في النّثر الروائيّ العربيّ.
لكن ما يلفت النظر في هذه الرّواية أن روح المكان بمعنى (فضائه الشّعري الروحيّ الاجتماعيّ) تحضر على نحو مميّز، وتشكل بعداً أساسياً يوجه عالمها الروائي برمّته ويستحضر الرّوح الحلبيّة المحلّيّة، وهي عمل فني يستحضر مكانا حلبيا يعطيه النكهة الحلبية ويُبنى بروح محلّيّة شعبيّة.
إن المكان في باب الجمر ينهض في فضاء السّرد الحكائيّ المشار إليه أعلاه، عالمٌ من الطّقوس والحكايات، وهذا ما يجعله وثيق الصلة بالبنية النفسية الشّعبية للجماعة.
إن أسلوبيّة السّرد الحكائيّ هنا، هي تعميم فنّيّ لعلاقات حضورية في الواقع، وما يوضح ذلك هو قيام الرواية على عالم من المتضادّات:
عالم الجماعة الشّعبية: أحمد النّسّاج، الصّالحانيّ، محبّة الجمر.
في مقابل عالم السّلطة: الذي هو عالم الأسطورة العائلية لـ آل الرّاس.
ونجد هذا التّضاد على مستوى الإشكالية الروائية في شكل الصّراع ما بين ثنائية عالم مقهور ومستغَلّ وفقير وجاهل، وعالم آخر يملك المعرفة ويملك في الوقت نفسه المال والقوة والسلطة والقدرة على تجهيل الآخرين واستغلالهم عن طريق جهلهم.
وقد يبدو أن الصّراع قائم بين المعرفة والسّلطة، وهنا قد تلعب المعرفة ـ إذا وجدت في عالم المقهورين ـ دوراً تقدمياً وتاريخيّاً، ولكنّه في رواية باب الجمر ضاعت المعرفة، وظل المقهورون في انتظار عودتها يوماً ما.
إن السّلطة لا تعارض إلا تلك المعرفة التي توقظ الفقراء، وتؤدّي إلى زعزعة الوضع الذي تستفيد منه.
والكاتب هنا يبني عالماً يقوم على ركيزتين أساسيّتين:
الأولى: حيّ باب الجمر.
والثانية: أسرة الرّاس.
حيّ باب الجمر: حيّ للفقراء يلتقي فيه أناس كثيرون تجمعهم صفة واحدة: كثرة الأبناء والفقر.
في مقابله، أسرة آل الرّاس بأعمدتها المختلفة التي تسيطر على الصّناعة والتجارة والمال والزّراعة.
أما المعرفة التي يحملها “محبّة الجمر” فإنها تتطوّر في الخطاب الروائي من معرفة بدائية حدسيّة تتواصل مع الطّبيعة إلى فعل اجتماعيّ ينتهك بأسئلته حرمة الأسطورة العائلية لآل الرّاس، ويكون محبّة الجمر ضحية هذه الأسئلة وشهيدها، لأنه ينتهك حرمة سيطرة رأس المال الطفيليّ والبيروقراطي في حارة “باب الجمر” الذي يستمد قوته أيضاً من استمرار تلك الأسطورة، وذلك جوهر البطولة الشعبية التي يمثلها محبّة الجمر بملحميتها الحكائية مصاغة بخيال شعبيّ.
والواقع، إنّ محبّة الجمر لم يولد على غرار أبطال الخيال الشّعبي فحسب، بل كان في موته شيء من ذلك أيضاً.
فالخطاب الروائيّ لم يقل إن محبة الجمر قد مات، بل يشي بأنه غاب وسيعود ثانية.
ولم يتفوق محبّة الجمر على الصّالحاني بالمعرفة، ولكنه تفوّق عليه في شعبيته وذكائه وجرأته.
هذه الصفات التي تجعلنا نحكم على وليد إخلاصي بأنه منسجم حتى نهاية الرواية في تصويره لشخصية محبّة الجمر التي لم تستطع جمانة ـ بكل ما تملكه من إغراء ـ أن تحرفه عن مطالبه. لماذا ؟؟ لأن الكاتب يرى في محبّة الجمر المُخَلـِّصَ الشّعبي ذا التصميم والجرأة والشجاعة والذكاء والقوة، وهذه هي صفات الشعب.
ولهذا لا تنطبق على الكاتب وليد إخلاصي تصنيفات جاهزة لأنه “رجل مفاجئ” بكتابته وأفكاره.
إن النّص الرّوائي يطرح هيمنة كاملة لأسرة “آل الرّاس” على مجتمع حارة “باب الجمر” بحيث إن هذه السيطرة لا تمسّ عالم العلاقات الحضورية الاجتماعية، وإنما تمسّ العلاقة الشعرية أيضا، بمعنى الفضاء الروحي والنفسي والحكائي.
إن ما يبدو من أصالة في أعمال وليد إخلاصي وخصوصاً في باب الجمر وزهرة الصندل، هو مظهر محدد من مظاهر الدفاع عن الروح الشعبية، وهذا لا يخفف التجريدية الذهنية لبناء المكان/الأمكنة، ولبناء الشخصيات، إنما يمنحها طابعا وثيق الصلة بخصائص اللغة، بل بخصائص الوعي الحكائي.
فقد استخدم الكاتب كل معارفه في كتابة هذه الرواية حتى أثقلها بالأفكار وجعل حوارها تكثيفاً لوعي كامل من مرحلة تاريخية معينة مُساقاً بلغة شعرية في كل جمل الحوار، وهذه الشاعرية بعيدة عن الترهل البلاغي العقيم.
فالبلاغة والرواية نقيضان، والرواية ليست فن كلمة، بل فن بناء وسرد وشخصيات ومشاهد وحوادث وأمكنة، ويسرد لنا الكاتب التفاصيل الجزئية لكل ذلك بحميميّة في إطار عرض ملحمي حكائي.
وفي معظم روايات وليد إخلاصي نجد الصراع بين مفهومين أخلاقيين متناقضين، وهذا ما يطبع إبداعه بطابع ذهني واضح، لكن هذه الذهنية لا تقلّل من حيوية عالمه الروائي الذي يبنيه بمقدرة مهندس معماري محترف ومجتهد.
وتتضح هذه الذهنية أكثر في باب الجمر رغم أن الصراع بين الخير والشر لا يمكن أن يحسم في جولة واحدة.
لقد أراد وليد إخلاصي أن يكتب في هذه الرواية تاريخ المدينة، تاريخ حلب، لكن ليس كالتّاريخ الذي كتبه كامل الغزّي، أو خير الدّين الأسديّ، أو راغب الطّبّاخ.
إنه يكتب ما يقول عنه: هذا تاريخي صار أنا.
* باب الجمر: رواية صادرة عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق ـ 1984
(نُشر المقال في العدد 1921 من الأسبوع الأدبي بتاريخ 11/9/2025)