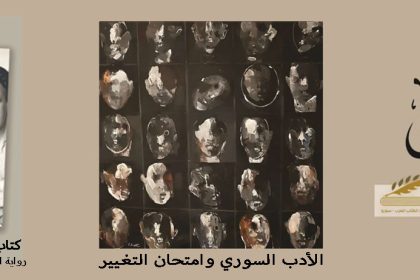د. راتب سكر
-1-
ذكر امرؤ القيس “حماة” في شعره قائلاً:
“تقطّعَ أسبابُ اللبانة والهوى – عشِيَّةَ جاوزنا “حَماةَ” و”شيزرا””.
وثمّة كتبُ تاريخ وأدب أوردتْ القصيدة التي ضمَّتْ هذا البيت، الذي أورده أبو الفداء في كتابه “المختصر في أخبار البشر” منفرداً، ولم يُشَرْ في الحالتين إلى ما فعله امرؤ القيس في “حماة” قبل أنْ يجاوزها، مما يترك الباب مفتوحاً لقبول تخميناتٍ شتَّى مثل وقوفه مفتوناً على ضفَّة عاصيها، وزرعه تميمةً من تمائم تعلّقِهِ بالشعر، وهُيامه بنجومه وأمراس كتَّانِه، في تراب تلك الضفّة التي هلّلت لضيفتها، واحتضنتها بعطفها وحنانها الأزليين اللذين أشار إليهما “ابن نباتة المصري” بقوله واصفاً العاصي في رثائه صديقه أبا الفداء:
“كأنَّه استشعرَ الأحزان من قدمٍ – فللنواعير نوحٌ في نواحيهِ”.
-2-
لله درّ ذيْنِكَ الترابِ والتميمة، فالذي عرف معاجمهما: إلهاماً وشعوراً، يستطيع أنْ يفسّر حيويّة شاعرِ مثل بدر الدين الحامد في لوَبانِهِ بين الأمكنة والأزمنة: جسداً وشعراً، فيسافر كثيراً إلى القدس، وحلب، وحمص، ودمشق وغيرها، راثياً إبراهيم هنانو، وسعدالله الجابري، وأخاه غير الشقيق نجيب الريّس، وغيرهم من أعلام زمانه، أو مبتهجاً متطاولاً بعزّة أوطانه، يكاد المنبر يميد تحتَ قدميه، والأعلام خافقة في فضائه، وهو يصيح ملء حَنْجرته وكِيانِه:
“يومُ الجَلاء هو الدنيا وبهجتُها – لنا ابتهاجٌ وللباغِين إرغامُ”.
لله درّ ذيْنِكَ الترابِ والتميمة، كم لهما من مهرجانٍ يتيه ببدرٍ من بدورهما وأقمارهما….
-3-
تتعاقب الأجيال الأدبيّة في الحواضر العربيّة ومهاجرها، متنوعّة الينابيع والمشارب والغايات، تنوّعاً يزيد مشاعلها توهّجاً ومدارسها ارتقاء، وقدْ تمثّلتْ مدارس الفكر والأدب في ربوع العاصي طبائع ذلك التعاقب: شعراً ونثراً، مدركة ما في تنّوعه من ثراء وإثراء، فوجدت دراسات اللاحقين كتابات السابقين في ميادين الشعر والسرد واللغة والفكر والعلم والترجمة، تلك الدراسات التي تنامت منذ مطالع القرن العشرين، وما تزال تتنامى تَتْرى، ملوّنة آفاق ثقافات المجتمع بعوامل نهضاتها وثّابة المطامح.
إنّ تميّز الأدب بصناعتين تمتلكان جناحين غير مثقلين بقيد من قيود عمياء، يمنحه فضاء من الحرّية تغبِطُهُ عليها، صناعات كثيرة لا تدرك كنه تلك الحرّية، التي تجعل من الأزمنة والأمكنة أساورَ تزيّنُ زنودَ غاياته ومراميه، فتراه ينقّل مهرجاناته، ونضج ثمار صناعتيه بين المدن والقرى، وما أسعدها تلك المدن والقرى التي لا تكسد فيها أسواقه متطاولة على انكسارات الأيّام، متحدّيةً حلكة لياليها، ومن أسعد من “حماة” في حملها هذه الأمانة الغالية، ألم يكتب أديب لبنان مارون عبود – أبو محمد – يوماً أنّ سوقَ الأدب في القرن الثامن الهجريّ – الرابعَ عَشَرَ الميلاديّ، قد كسدتْ، فلم يبق لها من رواج إلّا في “حماة” وبلاط ملكها “أبي الفداء”؟.
-4-
إنّ تنوُّعَ الأدب: ينابيعَ ومشاربَ وغاياتٍ، يفسّر لنا كيف عرفت “حماة” في وقت واحد قصائد تُحسَبُ على مدارسَ أدبيّة مختلفة، كتبها أدباء من جيل واد، أو أجيال متقاربة، أمثال: علي الناصر، وبدر الدين الحامد، وعمر يحيى (الفرجي)، ووجيه البارودي وغيرهم، ووصلت الصداة بين بعضهم – ولاسيّما الحامد والباودي – إلى مراتب سامية، لم يفسد مشارب كلّ منهم ومساربه: فكراً وأدباً، للودّ قضيّة.
يتحوّل فهمُ جوهر الحرّية إلى موقف سام في رؤى الأدباء، لذلك ترى في مسالكهم اليومية والأدبية رفعةً عامّة، تنفر من كلّ تنمّرٍ واستبداد، وما يتبدّى على صور تخالف ما في ذينك السموّ والرفعة من إباء وكبرياء، في أحيان قليلة، يتبدّى خجلاً من صغار مسعاه ومآله، وإن يعاند التطهّر بالشعر والنثر مما علق في يديه، تجده انزوى متعجرفاً متكبّرا.
-5-
لقد جاوز امرؤ القيس “حماة” يوماً، غير أنّ خيطاً من عباءته المطرّزة ظلّ عالقاً غصن شجرة مشمش في بساتينها، ومن يوما صار للشعر والمشمش في “حماة” قصائدُ إباء وحُبّ وكبرياء، ومواكبُ صداقاتٍ وإخاء، ومهرجاناتُ شعر ونثر وضياء!
(نُشر المقال كافتتاحية عدد الأسبوع الأدبي 1921)